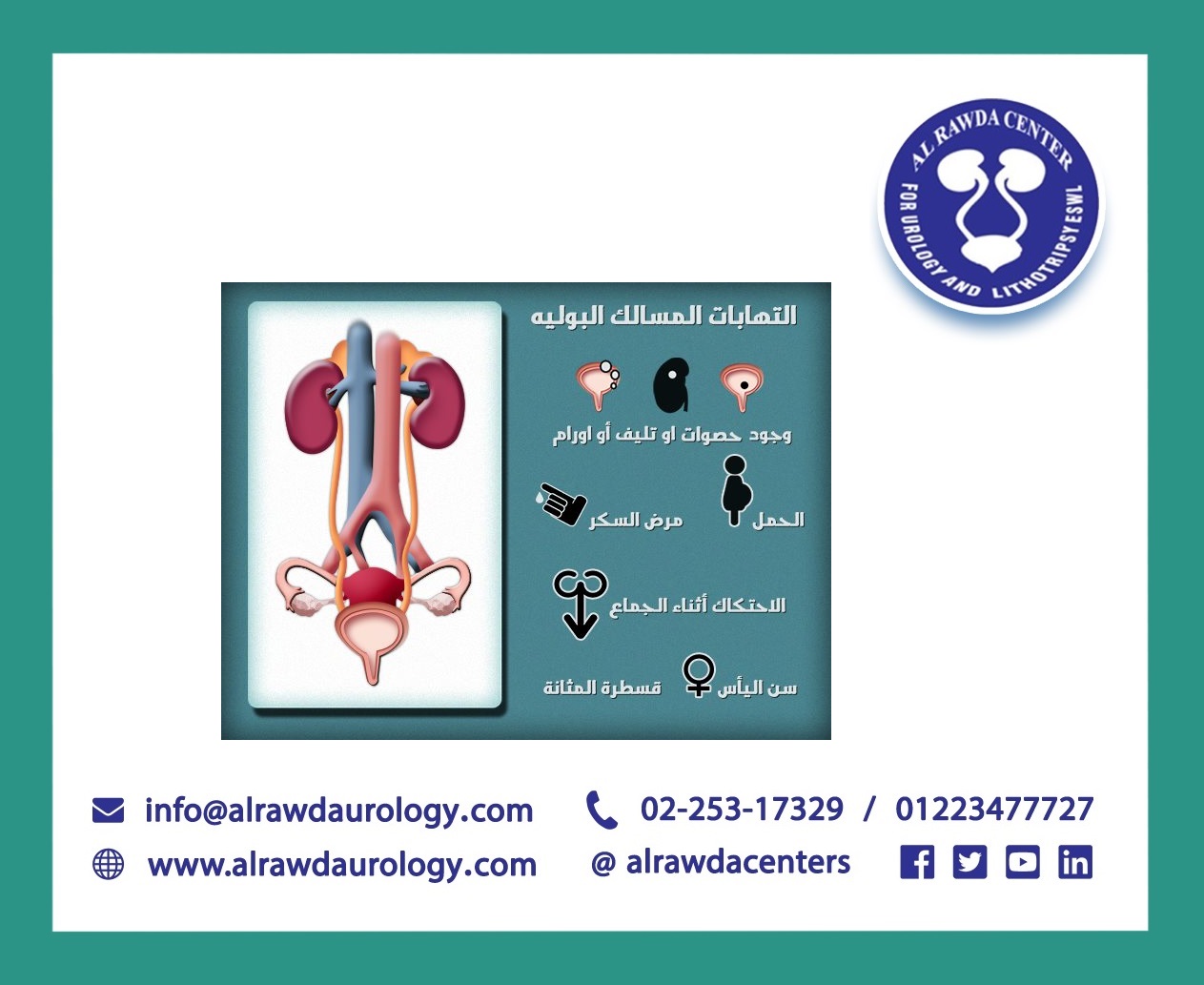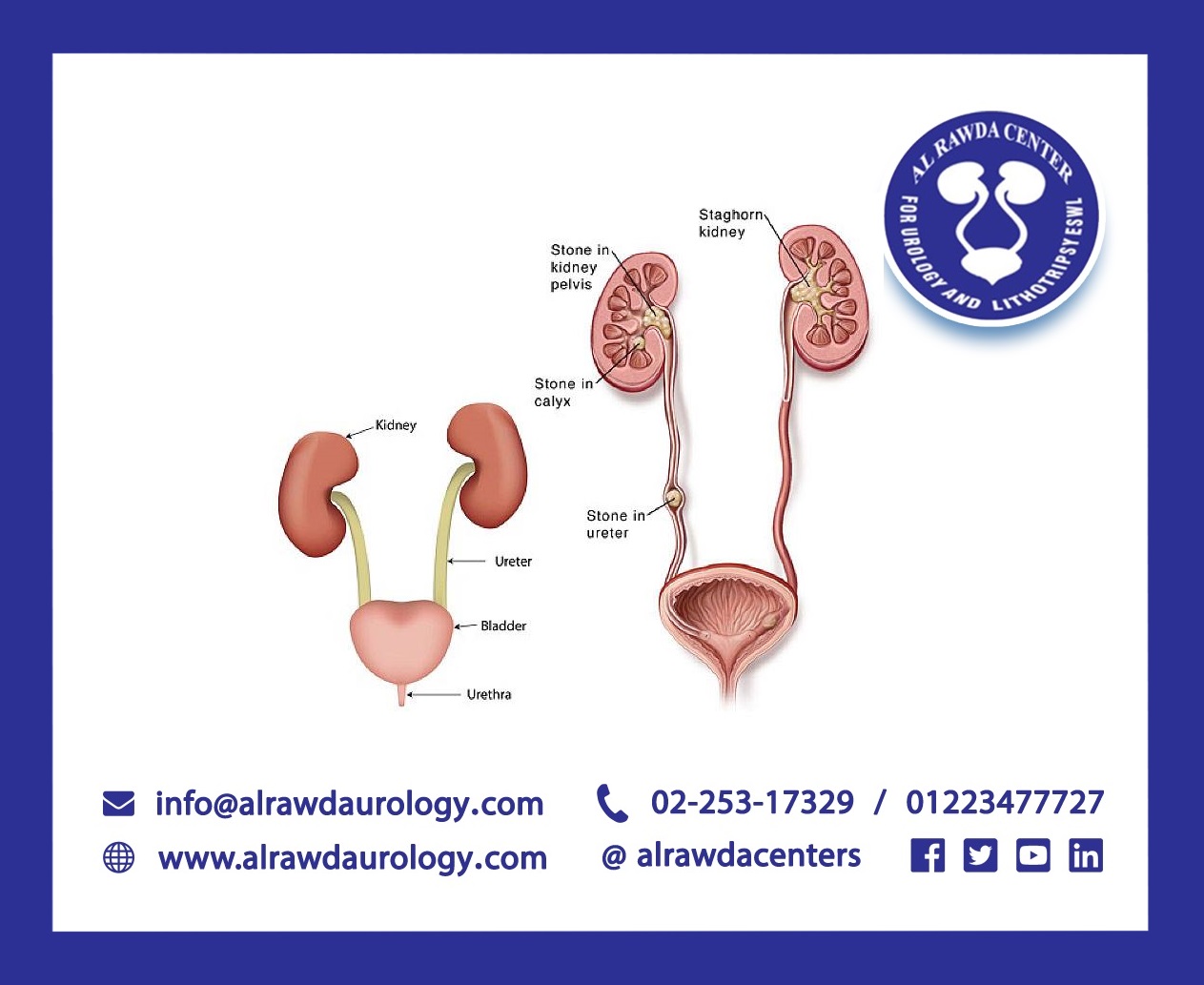- مركز الروضة للمسالك البولية وتفتيت حصوات الكلي
الهدف من زراعة الكلى هو توفير كلية تستطيع القيام بوظائفها، لشخص فقد الكلى لديه القدرة على أداء وظائفها، بسبب العديد من العوامل التي تسبب للوصول الى الداء الكلوي بالمرحلة النهائية (end-stage renal disease): مثل الفشل الكلوي المزمن (Chronic renal failure)، تضرر الكلى جراء السكري، فرط ضغط الدم الكلوي، عدوى كلوية مزمنة، إلحاق الضرر بالكلى بسبب الأدوية، تعرض شرايين الكلى للضرر، أمراض الكلى الوراثية، تضرر الكلى عقب مرض مناعة ذاتية (Autoimmune)وغيرها. يتسم الداء الكلوي بالمرحلة النهائية, بانخفاض معدل التصفية الكلوية لدرجة 20-25% من الوضع العادي (معدل الترشيح الكبيبي (GFR)) يمكن الحصول على كلية بغرض الزراعة إما عن طريق متبرع حي أو ميت، ولكن بكل تأكيد يتم تفضيل المتبرع الحي، بحيث يمكن إجراء الفحوصات الشاملة لهذا المتبرع قبل عملية الزرع، وهكذا يتم الحد من احتمالات رفض الجسم للزرع، ومن أجل زيادة احتمالات نجاح عملية الزرع لدى المريض. علاوة على ذلك فإن معدل حياة الكلية المأخوذة من المتبرع الحي أطول بضعفين من الكلية المأخوذة من جسم ميت. مجرى عملية زراعة الكلى يشمل عملية جراحية أولى للمتبرع من أجل إخراج الكلية السليمة (في معظم الحالات يتم ذلك عن طريق إحداث شق صغير واخراج الكلية عبر الجراحة بالمنظار)، والجراحة الثانية هي لدى مُستقبل الكلية من أجل زراعة الكلية في جسده. التحضير للجراحة: لا توجد حاجة في يومنا هذا لملائمة أنسجة الكلية أو فصيلة الدم من اجل القيام بزرع الكلى، بسبب وجود علاجات جيدة يتم استعمالها من بعد الزرع والتي تساهم في استقبال الجسم للزرع بنسبة نجاح عالية تصل إلى 85%. في الحالات التي لا يمكن بها استعمال هذه العلاجات، يجب حينها إيجاد متبرع ذو أنسجة كلوية ملائمة لحد معين (HLA) لكلية المريض كما يجب ملائمة صنف الدم. من بعد إيجاد هذا المتبرع الذي يمكنه أن يصمد من بعد إجراء الجراحة، عليه الإعلان بأنه تبرع من دوافع إنسانية وليس من دوافع مالية. الفحوصات المطلوبة من أجل القيام بالزرع لدى المريض الذي سيستقبل الزرع تشمل في بعض الأحيان فحص الكلى بالامواج فوق الصوتية (ultrasound) ، فحص العد الدموي الشامل-(CBC)، كيمياء الدم، فحص وظائف الكلى ونوع فصيلة الدم، وكذلك فحص البول. كذلك على المتبرع أن يقوم بمعظم هذه الفحوصات التي ذكرت أعلاه. على المريض استشارة الطبيب بشأن الأدوية التي يجب عليه أن يتوقف عن تناولها قبل الجراحة. كما يجب عليه أن يصوم لمدة 8 ساعات كاملة قبل الجراحة، التي يتم إجراؤها تحت تأثير التخدير العام. مجرى الجراحة: بنفس الوقت الذي يتم به إخراج الكلية من المتبرع يتم أيضا التحضير لجراحة زراعة الكلية في جسم المريض المُستقبِل. أولا يتم تعقيم منطقة البطن بشكل دقيق. من ثم, يتم القيام بشق البطن, بحيث يخترق الشق جميع طبقات الجلد، والأنسجة تحت الجلد، وعضلات وأغشية البطن حتى يتم الوصول إلى الكلية المتواجدة في القسم الخلفي الجانبي من البطن (الحيز خلف الصفاق (retroperitoneum)). من بعد تجريد الأوعية الدموية الكلوية، يتم نزع الكلية الغير فعالة من مكانها، ويتم وضعها بشكل جديد في تجويف الحوض (لا يتم نزع الكلى بشكل تام في معظم الحالات، إذ أن الأبحاث أظهرت أن إستئصال الكلية وإخراجها من الجسم مقترن بمعدل وفاة أكبر بعد الجراحة لذا فاليوم يتم إبقاء هذه الكلى في الجسم لكن في مكان أخر). من بعد ذلك يتم التأكد من سلامة تجويف البطن ويتم تحضيره من اجل القيام بالزراعة. يتم وصل الكلية الممنوحة إلى الأوعية الدموية الكلوية، ويجب التأكد من أن الدم يصلها بشكل جيد. في نهاية مرحلة الزرع يتم وصل الحالب (Ureter) من الكلية الجديدة إلى مثانة المريض. بعد ذالك يتم خياطة أغشية البطن، عضلات جدار البطن والطبقات الجلدية. يتم تضميد الشق الجراحي. في معظم الحالات يتم إبقاء أنبوب نازح داخل البطن (أنبوب موصول ببالون بلاستيكي)، من أجل استيعاب بقايا السوائل والنزيف الذي تراكم داخل تجويف البطن. تستغرق هذه الجراحة مدة 5 ساعات وحتى أكثر. مخاطر الجراحة: مخاطر عامة لكل العمليات الجراحية: عدوى في الشق الجراحي- في معظم الحالات تكون العدوى سطحية ويتم علاجها بشكل موضعي، ولكن في بعض الحالات النادرة قد تحدث عدوى خطيرة بطبقات الجلد، والأنسجة التحت جلدية أو في تجويف البطن. في بعض الحالات النادرة تكون هنالك حاجة لفتح الشق الجراحي من جديد لإخراج البقايا الجرثومية. نزيف- يحدث بالأساس في منطقة العملية بسبب تعرض الأنسجة في هذه المنطقة للرضح الموضعي. قد يحدث النزيف مباشرة بعد الجراحة وقد يظهر بعد 24 ساعة من انتهاء العملية وفي بعض الحالات النادرة قد يظهر بعد عدة أسابيع بل وأشهر. يحصل هذا النزيف نتيجة لتمزق ونزف الأوعية الدموية الصغيرة أو الكبيرة. في الحالات التي يكون فيها النزيف شديداً تكون هنالك حاجة للقيام بنزح إضافي. النزيف الشديد الذي قد يسبب لفقدان نسبة دم كبيرة قد يلزم إجراء جراحة من أجل إغلاق هذه الأوعية النازفة. ندبة- تتعلق طريقة شفاء الندبة بجودة الغرز وبالعوامل الوراثية. لا توجد أي طريقة تمكننا من توقع كيفية تماثل الندبة للشفاء بعد الجراحة. مخاطر التخدير- تتعلق معظم الأعراض بفرط التحسس للمواد المخدرة(إستجابة أرجية). في بعض الحالات النادرة, قد يحدث هبوط خطير في ضغط الدم (صدمة تأقية (Anaphylactic shock). المخاطر الخاصة بهذه الجراحة: تعرض الأوعية الدموية الكلوية للضرر- عقب ربطها أو بسبب استعمال أدوات الجراحة الحادة- نادر الحدوث. تعرض الحالب للضرر. رفض حاد للزرع- والذي يظهر على شكل رد فعل مناعي حاد من قبل الجسم ضد الكلية المزروعة، في حال حدوث ذالك حتى 60 يوم من بعد القيام بالزرع. يتم اليوم تناول أدوية عديدة لمنع ذلك. العلاج بعد الجراحة: بعد زرع الكلية، يجب على المريض الاستلقاء في المستشفى من أجل التعافي وليبقى تحت المراقبة لمدة 4-7 أيام. ففي معظم الحالات تقوم هذه الكلية المزروعة بتزويد البول بشكل فوري، وتصل إلى نسبة أداء طبيعية خلال أسبوع أو أسبوعين (الكلية المأخوذة من جسد ميت تحتاج الى وقت أكثر حتى تصل إلى نسبة الأداء الطبيعية). في حال تم إثبات وجود مشاكل بالتبول، يتم إضافة أدوية مدرة للبول من أجل مساعدة الكلية الجديدة على العمل. كما ذكر يتم تناول أدوية من اجل تثبيط الجهاز المناعي للمريض، بهدف منع رفض الزرع بقدر الإمكان. يتم استعمال هذه الأدوية لفترات طويلة وفي بعض الحالات يتم تناولها لمدى الحياة، ولكنها تتطلب إجراء متابعة مكثفة لفحوصات الدم ووظائف الكلى بسبب تأثيراتها الجانبية المتنوعة. في حال شعر المريض بالألم بعد عملية زراعة الكلية, يمكنه تناول مسكنات الألم بحسب الحاجة. يتم إزالة الكمادات والغرز من الشق الجراحي غالباً بعد أسبوع من الجراحة. في كل حالة يطرأ فيها ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، هبوط ضغط الدم، أو احتباس البول يجب إعلام الطبيب المعالج.