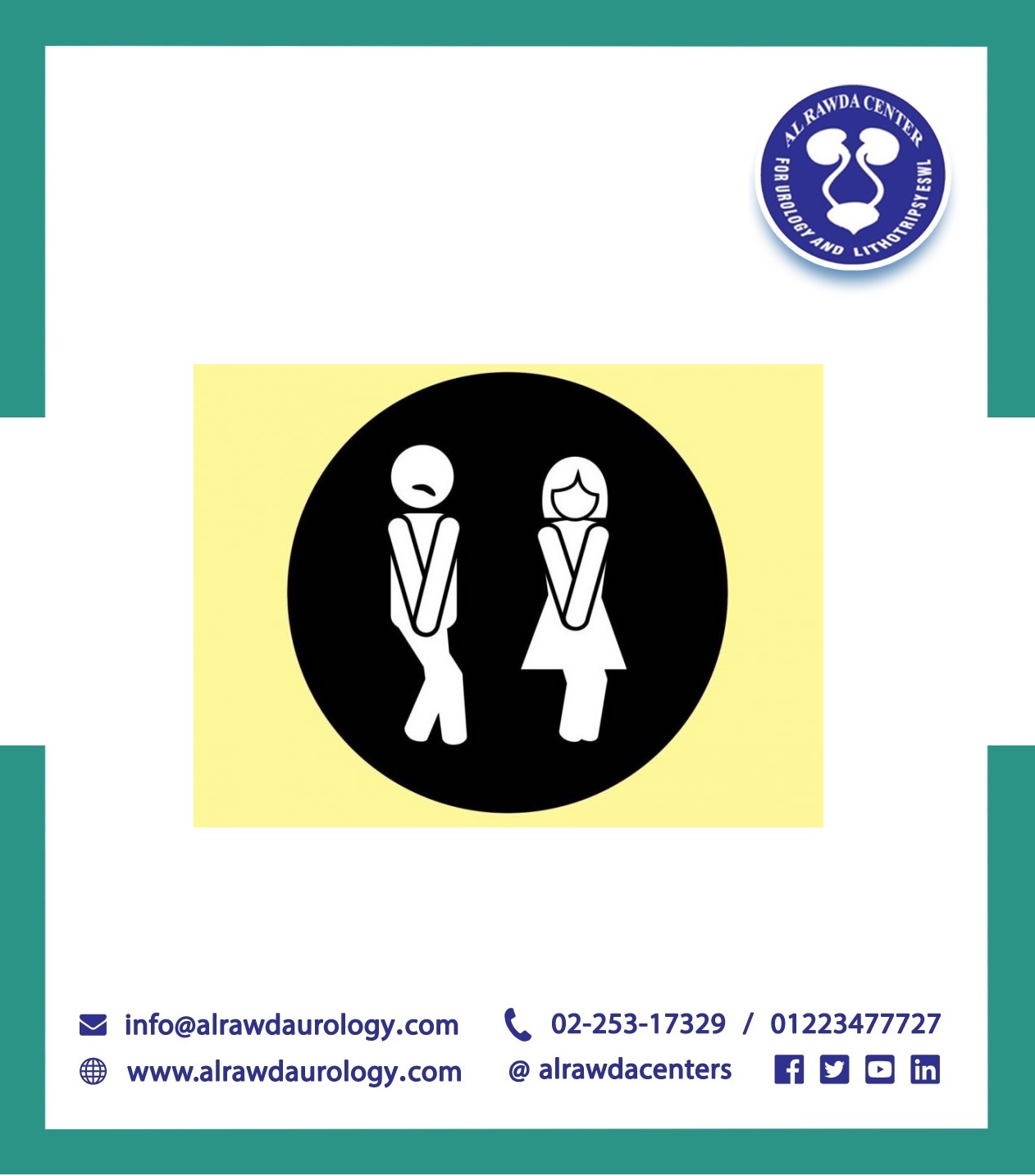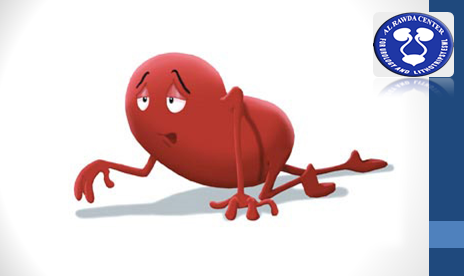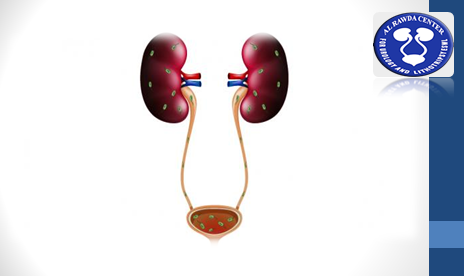ما هو السلس البولي عند الرجال
السلس البولي عند الرجال يمكن تعريف مشكلة السلس البولي (بالإنجليزية: Urinary Incontinence) بأنّها عدم القدرة على حبس أو إطلاق البول على الوجه المطلوب، أيّ بمعنى آخر أنّ المصاب يُسرّب البول دون إدراك، وفي الحقيقة يُمكن أن تُصيب هذه المشكلة الأفراد على اختلاف الفروقات بينهم، إلا أنّها عادةً ما تُصيب كبار السن بشكلٍ أكبر، هذا بالإضافة إلى أنّ هناك أنواع مختلفة للسلس البولي، منها ما يظهر لدى الرجال بشكلٍ أكبر من النساء.[١] أسباب السلس البولي عند الرجال تتعدد الأسباب الكامنة وراء المعاناة من السلس البولي عند الرجال، وأغلبها يرتبط بمشاكل البروستاتا، ويُمكن بيان بعض من هذه الأسباب فيما يأتي: انقباض المثانة البولية في الوقت الخاطئ أو انقباضها بقوةٍ تفوق الحدّ الطبيعيّ. ضعف العضلات المُحيطة بالإحليل أو تلفها، فيُمكن أن تتسبّب هذه المشكلة بالسلس البولي حتى لو لم يُعاني المصاب من أيّة مشاكل في المثانة البولية. عدم إفراغ المثانة البولية في الوقت اللازم، فتراكم البول في المثانة بشكلٍ يفوق قدرتها على التحمل يتسبّب بتسريب البول. حدوث انسداد في الإحليل لسببٍ أو لآخر، ومن الأسباب التي تكمن وراء هذه المشكلة: تضخم غدة البروستاتا أو المُعاناة من ضيق الإحليل. أسباب أخرى: كشرب الكحول وتناول بعض أنواع الأدوية. أنواع السلس البولي عند الرجال توجد عدة انواع للسلس البولي عند الرجال ويُمكن ذكر بعض منها فيما يأتي: سلس البول الإجهادي: (بالإنجليزية: Stress urinary incontinence)، وعادةً ما يُعاني المصاب من هذا النوع من السلس عند السعال، أو العطاس، أو ممارسة الرياضة، أو القفز، أو حمل الأشياء. سلسل البول الإلحاحي: (بالإنجليزية: Urge urinary incontinence)، ومن مُحفّزات هذا النوع من السلس: الطقس البارد، وغسل اليدين، ومشاهدة جريان الماء، وغير ذلك. سلس البول المختلط: (بالإنجليزية: Mixed urinary incontinence)، وهو السّلس الذي يُعاني فيه المُصاب من خصائص النّوعين المذكورين سابقاً. سلس البول الوظيفي: (بالإنجليزية: Functional incontinence)، ويرتبط بوجود مشكلة على مستوى الحركة أو القدرات العقلية. مركز الروضة للمسالك البولية و تفتيت الحصوات يعدكم بنتائج طبية أفضل رعايه ترقي لثقتك دمتم بصحه جيده للحجز والاستعلام يرجي التواصل معنا : مواعيد العمل بمركز الروضة : طوال أيام الاسبوع ماعدا الجمعة (9 صباحأ : 5 مساءأ ) . https://alrawdaurology.com/ هاتف مركز الروضة واتساب و اتصال : 01223477727 -01128485351 عنوان مركز الروضة : 34 شارع الاخشيد – منيل الروضة – امام مستشفى الزهيرى – القاهرة